الأمثال فى القرآن الكريم

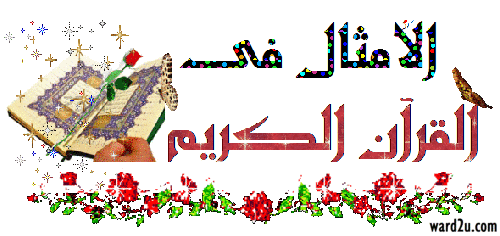
الأمثال فى القرآن الكريم
********************
القرآن الكريم كتاب تشريع و تربية
كتاب هداية وإصلاح
و ليس كتاب أحكام فقط،
بل بالقرآن نستطيع أن نضع منهجا للمجتمع بأكمله
يحل كل المشاكل و يعالج كل صعب
لا عجب فهو كتاب الله الذي نزل تبيانا
لكل شيء و هدى و رحمة للعالمين
و من أبرز الجوانب التي اعتنى بها القرآن الكريم
جانب الأمثال التي تضرب لنا أروع التوجيهات
و أبلغها في تشكيل الشخصية الإسلامية
و تحصينها من العوامل الهدامة و الشبه الزائفة
التي تخرج من الكفار و العلمانيين و الليبراليين
و الفساق و أهل الفساد عموما

و ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز دلَّ على هذا الكتاب نفسه
فقال تعالى :
وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
الحشر - الآية 21
و قال تعالى :
﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾
العنكبوت - الآية 43
وقال تعالى:
وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
الزمر- الآية 27
و دل على هذا قوله عليه الصلاة و السلام
فيما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه :
إنَّ الله أنزل القرآن آمرًا و زاجرًا و سنة خالية و مثلاً مضروبًا

فللأمثال أثر بليغ في تلقي الدعوة بالقبول
لذلك أحرَزَتْ بين الأساليب التي يتحرَّاها
القرآن في هدايته منزلة سامية
ود عا ربُّ العزة سبحانه و تعالى
النَّاسَ أن يستمعوا إلى الأمثالِ و يتدبروها
و يتفكروا فيما تشيرُ إليه من كرائمِ المعاني
و يعقلوا ما توحي إليه من غوالي الحكم و المواعظ
قال تعالى :
ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُو
ا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ
[محمد : 3].

فالله قد ضربَ الأمثالَ للناس
وقام الشاهد من أنفسهم، وممن حولهم
على أنه الواحد الأحد ورب كل شيء وخالقه،
وبيَّن في الأمثالِ الخيرَ وما يؤدِّي إليه،
وما يعود على صاحبِه منه،
خاطب الذين يسمعون ويبصرون
ويستعملون عقولَهم في التذكرِ والتفكُّر والتدبُّر.
وقد جاء في القرآن ثلاثةٌ وأربعون مثلاً
لا يتدبَّرها ولا يستطعِمُ بلاغتَها إلا من له عقلٌ حيٌّ ولُبٌّ يلمَح،
قال أحد السلف: "كنتُ إذا قرأتُ مثلاً من القرآن
فلم أتدبَّره بكيتُ على نفسي؛ لأن الله يقول:
﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾
[العنكبوت: 43]".

ولقد ضرب الله لنا في القرآن أمثالاً متنوعة
لم تكن قاصرةً على خلقٍ دون آخر؛
فقد يضربُ الله المثلَ في نباتٍ؛ كقوله تعالى:
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾
[إبراهيم: 24]،
وقد يضرب الله المثلَ بحيوانٍ أعجم؛
كما ذكر عن الذي آتاه آياته فانسلَخَ منها،
فأتبعَه الشيطان فكان من الغاوين، وذلك كقوله:
﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ
ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾
[الأعراف: 176]،
وقد يضربُ الله مثلاً بالإنسان،
كما في قوله: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ
لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ
لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾
[النحل: 76].

وعجَبٌ حينما يضربُ الله مثلاً لعباده بالحشرات
التى هى أحقر مخلوقاته وأصغرها؛
فقد قال تعالى عن العنكبوت:
﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ
اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾
[العنكبوت: 41]،
وقد ضرب الله لنا مثلاً أيضًا بالبعوضة الصغيرة
التي لا نأبَهُ لها ولا نُعيرُها اهتمامًا إلا في قتلها،
تلكم البعوضة التي قال الله عنها:
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾
[البقرة: 26]،

وإن العجبَ ليزداد حينما يضربُ الله لنا مثلاً في الذُّباب،
ذلكم المخلوق الذي يأنَفُ منه العموم تأفُّفًا وازدراءً،
ويخُصُّه الله بالحضِّ على الإنصات والاستماع إليه
بخلاف غيره من الأمثال، فيقول - سبحانه -:
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ
وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ
ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ *
مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾
[الحج: 73، 74].

فلله ما أعظم هذه الأمثال
وما أعظم ما تحويه من نهايةٍ في العِظَة والعِبرة،
ونهايةٍ في البلاغة وإيجاز اللفظ وحُسن التشبيه وقوة الكناية،
ولقد صدقَ الله - سبحانه - إذ يقول:
﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ
جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾
[الزمر: 23].


الأمثال فى القرآن الكريم
********************
القرآن الكريم كتاب تشريع و تربية
كتاب هداية وإصلاح
و ليس كتاب أحكام فقط،
بل بالقرآن نستطيع أن نضع منهجا للمجتمع بأكمله
يحل كل المشاكل و يعالج كل صعب
لا عجب فهو كتاب الله الذي نزل تبيانا
لكل شيء و هدى و رحمة للعالمين
و من أبرز الجوانب التي اعتنى بها القرآن الكريم
جانب الأمثال التي تضرب لنا أروع التوجيهات
و أبلغها في تشكيل الشخصية الإسلامية
و تحصينها من العوامل الهدامة و الشبه الزائفة
التي تخرج من الكفار و العلمانيين و الليبراليين
و الفساق و أهل الفساد عموما
و ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز دلَّ على هذا الكتاب نفسه
فقال تعالى :
وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
الحشر - الآية 21
و قال تعالى :
﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾
العنكبوت - الآية 43
وقال تعالى:
وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
الزمر- الآية 27
و دل على هذا قوله عليه الصلاة و السلام
فيما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه :
إنَّ الله أنزل القرآن آمرًا و زاجرًا و سنة خالية و مثلاً مضروبًا
فللأمثال أثر بليغ في تلقي الدعوة بالقبول
لذلك أحرَزَتْ بين الأساليب التي يتحرَّاها
القرآن في هدايته منزلة سامية
ود عا ربُّ العزة سبحانه و تعالى
النَّاسَ أن يستمعوا إلى الأمثالِ و يتدبروها
و يتفكروا فيما تشيرُ إليه من كرائمِ المعاني
و يعقلوا ما توحي إليه من غوالي الحكم و المواعظ
قال تعالى :
ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُو
ا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ
[محمد : 3].
فالله قد ضربَ الأمثالَ للناس
وقام الشاهد من أنفسهم، وممن حولهم
على أنه الواحد الأحد ورب كل شيء وخالقه،
وبيَّن في الأمثالِ الخيرَ وما يؤدِّي إليه،
وما يعود على صاحبِه منه،
خاطب الذين يسمعون ويبصرون
ويستعملون عقولَهم في التذكرِ والتفكُّر والتدبُّر.
وقد جاء في القرآن ثلاثةٌ وأربعون مثلاً
لا يتدبَّرها ولا يستطعِمُ بلاغتَها إلا من له عقلٌ حيٌّ ولُبٌّ يلمَح،
قال أحد السلف: "كنتُ إذا قرأتُ مثلاً من القرآن
فلم أتدبَّره بكيتُ على نفسي؛ لأن الله يقول:
﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾
[العنكبوت: 43]".
ولقد ضرب الله لنا في القرآن أمثالاً متنوعة
لم تكن قاصرةً على خلقٍ دون آخر؛
فقد يضربُ الله المثلَ في نباتٍ؛ كقوله تعالى:
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾
[إبراهيم: 24]،
وقد يضرب الله المثلَ بحيوانٍ أعجم؛
كما ذكر عن الذي آتاه آياته فانسلَخَ منها،
فأتبعَه الشيطان فكان من الغاوين، وذلك كقوله:
﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ
ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾
[الأعراف: 176]،
وقد يضربُ الله مثلاً بالإنسان،
كما في قوله: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ
لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ
لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾
[النحل: 76].
وعجَبٌ حينما يضربُ الله مثلاً لعباده بالحشرات
التى هى أحقر مخلوقاته وأصغرها؛
فقد قال تعالى عن العنكبوت:
﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ
اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾
[العنكبوت: 41]،
وقد ضرب الله لنا مثلاً أيضًا بالبعوضة الصغيرة
التي لا نأبَهُ لها ولا نُعيرُها اهتمامًا إلا في قتلها،
تلكم البعوضة التي قال الله عنها:
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾
[البقرة: 26]،
وإن العجبَ ليزداد حينما يضربُ الله لنا مثلاً في الذُّباب،
ذلكم المخلوق الذي يأنَفُ منه العموم تأفُّفًا وازدراءً،
ويخُصُّه الله بالحضِّ على الإنصات والاستماع إليه
بخلاف غيره من الأمثال، فيقول - سبحانه -:
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ
وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ
ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ *
مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾
[الحج: 73، 74].
فلله ما أعظم هذه الأمثال
وما أعظم ما تحويه من نهايةٍ في العِظَة والعِبرة،
ونهايةٍ في البلاغة وإيجاز اللفظ وحُسن التشبيه وقوة الكناية،
ولقد صدقَ الله - سبحانه - إذ يقول:
﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ
جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾
[الزمر: 23].
تعليق